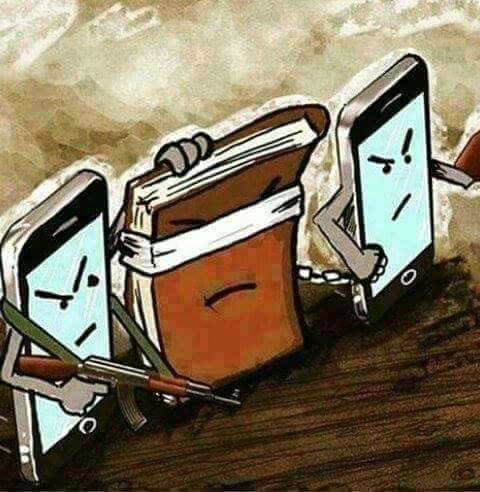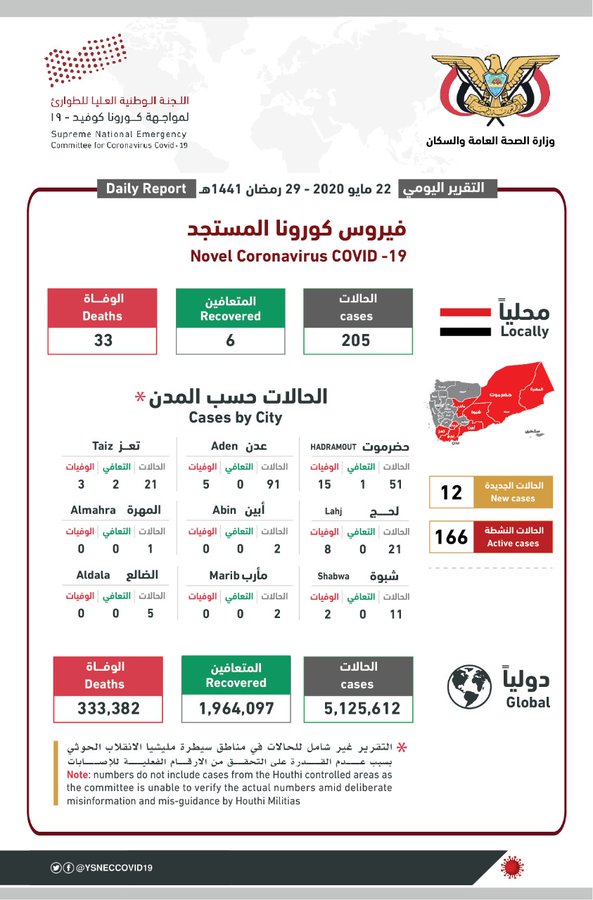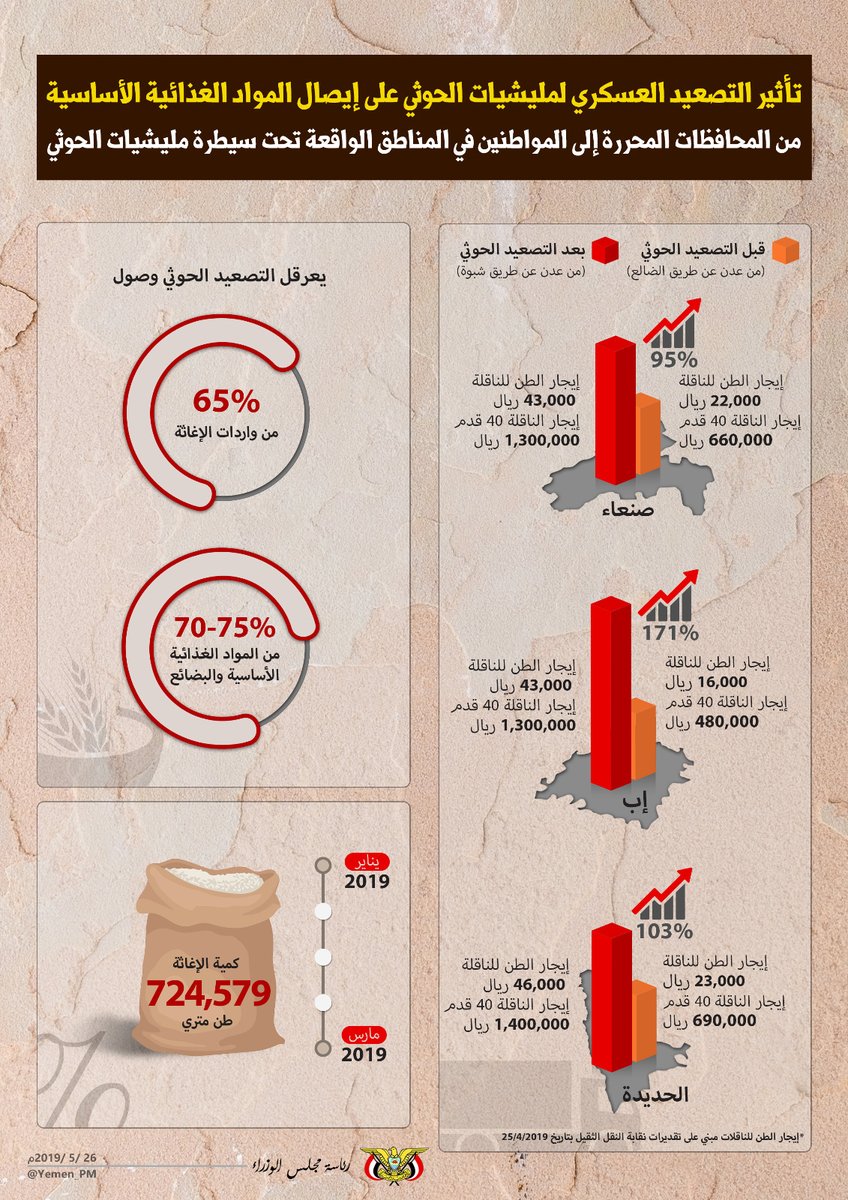لم نجد سببا لعدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لفواتح السور وقد ذكرنا بالفتوى رقم: 107043، أن تفسير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للقرآن الكريم كان مركزا على الجانب العملي أكثر من النظري، فكان يطبقه في حياته وفي واقع الناس، فبين صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه بالقول وهو قليل، ولكن البيان العملي كان هو الأساس.
ولهذه الأسباب وغيرها فإن القرآن الكريم لم يفسر في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تفسيرا شاملا لكل ما تحتمله دلالات ألفاظه. وأما الصحابة فلا يستغرب عدم سؤالهم عنها، فقد كان جمع من أجلائهم يعتبرها من سر القرآن الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ونقل ذلك عن الخلفاء الراشدين، فقد قال الإمام القرطبي في تفسيره عن معاني الحروف المقطعة في أوائل بعض السور: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت، وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر، وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله جل وعز بها، قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدثنا الحسن بن الحباب حدثنا أبو بكر بن أبي طالب حدثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به، وما بكل القرآن تعلمون، ولا بكل ما تعلمون تعملون، قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن ستر معانيها عن جميع العالم، اختباراً من الله عز وجل وامتحاناً، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد. انتهى.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
ويؤيد هذا ما ذهب اليه ابن حزم من منع السؤال عن فواتح السور؛ لأنها من المتشابه فقد جاء في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/ 124) : فحرام على كل مسلم أن يطلب معاني الحروف المقطعة التي في أوائل السور مثل {كهيعص} و{حم عسق} و{ن} و{الم} و{ص} و{طسم} اهـ
ويحتمل أنهم لم يسألوا عنها لوضوح المراد منها وهو تحدي العرب، فقد قال ابن عاشور في تفسيره في عرضه للأقوال الواردة في تفسيرها: إنها سيقت مساق التهجي مسرودة على نمط التعديد في التهجية تبكيتا للمشركين وإيقاظا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد تحدوا بالإتيان بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم، كأنه يغريهم بمحاولة المعارضة، ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف ومعالجة النطق تعريضا بهم بمعاملتهم معاملة من لم يعرف تقاطيع اللغة، فيلقنها كتهجي الصبيان في أول تعلمهم بالكتاب حتى يكون عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجزا لا معذرة لهم فيه، وقد ذهب إلى هذا القول المبرد وقطرب والفراء، قال في «الكشاف» وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزلة، وقلت: وهو الذي نختاره، وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن كل سورة مقصودة بالإعجاز؛ لأن الله تعالى يقول: فأتوا بسورة من مثله [البقرة: 23] فناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد لمحاولته، ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا المقصد؛ فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمره، وأن التهجي معروف عندهم للتعليم، فإذا ذكرت حروف الهجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام غير صالح للتعليم عرف السامعون أنهم عوملوا معاملة المتعلم؛ لأن حالهم كحاله في العجز عن الإتيان بكلام بليغ، ويعضد هذا الوجه تعقيب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن وتنزيله أو كتابيته إلا في كهيعص [مريم: 1] والم أحسب الناس [العنكبوت: 1، 2] والم غلبت الروم [الروم: 1، 2]. اهـ